في أحدث مؤلفاته، يتناول الكاتب والمفكر الكندي جون روبسون السياسة من زاوية مختلفة، يصفها كمن يدرس مرضًا لا رغبة له فيه، بل ضرورة علمية. يقول: “رغم أنني قضيتُ حياتي أتابع السياسة، لا أظن أنني أحبها”. هذه الجملة تختصر الكثير: فبالنسبة له، السياسة ليست ميدانًا للمثالية أو الحماسة، بل حقلًا معقدًا من التفاعلات البشرية، أقرب إلى دراسة الطبيب للأمراض المستعصية. يضع على رفوفه كتب الطغاة مثل هتلر وستالين جنبًا إلى جنب مع منظري الاقتصاد مثل كينز وفريدمان، وكأنما يضع يده على الجمرين: القمع والنفوذ من جهة، والمصالح والحوافز من جهة أخرى.
لكن النقطة المحورية في طرحه ليست في الغوص في الأسماء، بل في المفهوم الأهم الذي يشكل نسيج حديثه: الحوافز.
في أحدث مؤلفاته، يتناول الكاتب والمفكر الكندي جون روبسون السياسة من زاوية مختلفة، يصفها كمن يدرس مرضًا لا رغبة له فيه، بل ضرورة علمية. يقول: “رغم أنني قضيتُ حياتي أتابع السياسة، لا أظن أنني أحبها”. هذه الجملة تختصر الكثير: فبالنسبة له، السياسة ليست ميدانًا للمثالية أو الحماسة، بل حقلًا معقدًا من التفاعلات البشرية، أقرب إلى دراسة الطبيب للأمراض المستعصية. يضع على رفوفه كتب الطغاة مثل هتلر وستالين جنبًا إلى جنب مع منظري الاقتصاد مثل كينز وفريدمان، وكأنما يضع يده على الجمرين: القمع والنفوذ من جهة، والمصالح والحوافز من جهة أخرى.
لكن النقطة المحورية في طرحه ليست في الغوص في الأسماء، بل في المفهوم الأهم الذي يشكل نسيج حديثه: الحوافز.
فبالنسبة لروبسون، الفهم الحقيقي لكيفية سير العالم –سواء في الأسواق أو في دوائر السلطة– يبدأ من إدراك تأثير الحوافز على سلوك الأفراد. نعم، الأمر بهذه البساطة وبهذا التعقيد في آنٍ معًا.
يستعرض الكاتب مشهدًا من الواقع السياسي: منحة حكومية ذات طابع “مؤقت” تهدف ظاهريًا لدعم المجتمع، لكن في جوهرها تخدم السياسيين في تعزيز فرص إعادة انتخابهم. يصف أحد المراقبين بذكاء هذه المنحة بأنها “طريقة فعالة لكسب حسن النية، لكنها ليست منطقية اقتصاديًا عند التفكير في كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب”. تعليق يبدو موضوعيًا، لكن روبسون يراه نصف الحقيقة فقط. فهو يرى أن هذا السلوك –رغم أنه مرفوض من ناحية المبادئ الاقتصادية السليمة– يعكس منطقًا عقلانيًا تمامًا ضمن بيئة يغلب عليها الطمع والحسابات الشخصية. فالسياسي، ببساطة، يستجيب للحوافز المتاحة له، تمامًا كما يفعل أي شخص آخر.
هنا تبرز المفارقة الأساسية التي يبني عليها الكاتب فكرته: الناس يستجيبون للحوافز. وهذه ليست مجرد ملاحظة اقتصادية، بل حجر الزاوية في نظرية “الاختيار العام”، التي تنقل مفاهيم السوق إلى عالم السياسة، لتكشف أن من يعملون في القطاع العام لا يتجردون من دوافعهم الشخصية، بل على العكس، قد تكون الحوافز في هذا العالم أشد التواءً، وأبعد عن الشفافية.
ينتقد روبسون النظرة الرومانسية التي تتهم الأسواق بالجشع وتُمجّد دور الدولة كراعية للقيم والمبادئ. يرد بذكاء قائلاً: “الأسواق لا تُدار بالجشع، ولا يمكنها أن تقوم عليه أصلًا”. يستعير كلمات آدم سميث ليؤكد أن التعاملات في السوق لا تقوم على التعاطف، بل على المصالح المتبادلة، وأن نجاح أي تاجر –سواء كان جزارًا أو خبازًا أو صانع جعة– مرهون بتقديمه قيمة حقيقية لزبائنه. العلاقة قائمة على نفع متبادل، بل وقد تتطور إلى ثقة متبادلة بمرور الوقت. أما من يغش أو يطمع، فسوقه مهدد بالانهيار، وعقابه الإفلاس.
لكن حين ينتقل الأمر من السوق إلى صناديق الاقتراع، تتغير قواعد اللعبة. في السياسة، اللاعبون هم السياسيون والبيروقراطيون والناخبون، والجميع يُفكّر في مصالحه. السياسي يهمه الفوز أو إعادة الانتخاب، البيروقراطي يسعى وراء الأمان الوظيفي والترقيات، والناخب يريد أكبر قدر من المنافع بأقل تضحية ممكنة. وهنا تبدأ الحوافز في خلق “فخاخ” معقدة يصعب الخروج منها.
والمفارقة المؤلمة أن الحكومة، خلافًا للتاجر، تستطيع أن تفرض بالقوة ما تريد: الضرائب، القوانين، الإجراءات. والناخب في الديمقراطية يستطيع –بصوته– أن يفرض على الآخرين ما لا يرضاه لنفسه، ما دام سيستفيد شخصيًا.
هذا لا يعني، بحسب روبسون، أن الدولة شرٌ مطلق أو أن السياسة بلا فائدة. بل على العكس، هو يذكّرنا بجوهر الدولة كما تصوره جون لوك: ككيان نلجأ إليه لحماية حقوقنا الطبيعية عندما نعجز عن ذلك بمفردنا. لكنه يُحذرنا في ذات الوقت من خطورة ترك الباب مفتوحًا للغنائم السياسية بلا قيود. ففي لحظة ما، يبدأ الناس في البحث عن طرق قانونية لنقل أموال الدولة إلى جيوبهم الخاصة، ويندفعون في سباق جشع لا يُبقي ولا يذر، قد ينتهي بإفلاس الدولة وتآكل ثقة الناس بها.
من هنا، يرى أن الحل لا يكمن في إلغاء الدولة، بل في فرض قيود دستورية صارمة على سلطاتها، بما يضمن توازنًا صحيًا بين ما يستطيع السياسيون تقديمه، وما ينبغي عليهم فعله فعلاً، وبين ما يطلبه المواطنون، وما هو مستدام أخلاقيًا واقتصاديًا.
ويختتم الكاتب فكرته بالعودة إلى ذلك المثال الواقعي: السياسيون الذين يشترون “حسن النية”، والناخبون الذين يبيعونها. يقول إنها “طريقة ماكرة جدًا، لكنها خسيسة وغير مستدامة لإنفاق المال”، لأنها تقوم على استغلال مال الآخرين، وغالبًا ما يُترك العبء الأكبر على عاتق الأجيال القادمة، من أطفال المدارس الذين لم يدخلوا بعد دائرة التأثير.
في الأسواق، يستمر فقط من يُقدّم قيمة حقيقية. أما في السياسة، فمن ينجو غالبًا هو من يتقن لعبة المكاسب قصيرة الأمد على حساب المستقبل. ولذا، فإن أول خطوة نحو التغيير تكمن في فهم هذه الحقيقة القاسية، لأنه ما لم ندرك من أين يأتي الخلل، ستظل الحيرة والغثيان رفيقنا كلما حاولنا فهم ما يجري حولنا.
ماري جندي
المزيد















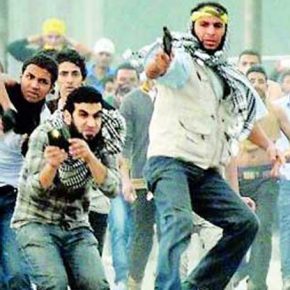




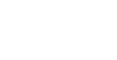



1